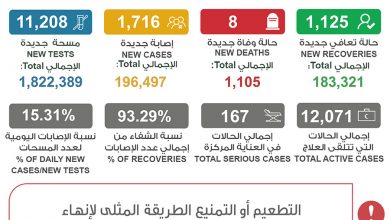“أدمنت المسكنات عندما كنت في الـ16 من عمري”

[ad_1]

مصدر الصورة
Thomas Dowse
الكلام لكايتي، البالغة من العمر 26 عاما
في إحدى ليالي العام الماضي كنت مستلقية إلى جانب رفيقي منتظرة لحظة خلوده للنوم. وبمجرد أن غط في النوم، انحنيت من فوقه وأمسكت بحقيبتي التي كانت موضوعة على الأرض على الجانب الذي كان يشغله من الفراش وبدأت بتفتيش علب الحبوب الفارغة التي كانت فيها لعلني أعثر على علبة جديدة من مسكّن “كوكودامول” قوي المفعول (كوكودامول يحتوي على الكودايين والأسيتامينوفين).
أيقظت الأصوات رفيقي الذي نظر إليّ وقال “تناولتِ بعضا من هذه الحبوب قبل دخولك الفراش. لمَ تحتاجين المزيد منها؟”
رددت عليه وانا أفتش الحقيبة “أشعر بألم. عد للنوم”.
قال لي “كايتي، أخشى أن يأتي يوم تتناولين فيه كمية كبيرة من الحبوب بحيث لن تستقيظي من نومك أبدا”. كانت كلماته بمثابة الصفعة في وجهي.
بدأت محنتي عندما كنت في الـ 16 من عمري. ففي يوم من الأيام، نقلت إلى المستشفى كحالة طارئة، وظن الأطباء أني مصابة بالتهاب الزائدة الدودية. كنت جالسة في البيت اتابع برامج التلفزيون عندما شعرت فجأة بألم فظيع في جهتي اليمنى أشبه ما يكون بركلة في المعدة.
أُدخلت صالة العمليات لإجراء عملية استئصال الزائدة، ولكن تبين للجراحين بأن ذلك لم يكن مصدر الألم المبرح الذي كنت أشعر به، بل استنتجوا بأنه تسبب عن انفجار كيس في المبيض استأصلوه على الفور. عدت إلى الوعي في المستشفى، وكنت أشعر بدوار وكان والدي القَلِق يجلس إلى جوار سريري.
في اليوم التالي، أُخرجت من المستشفى، وكنت بالكاد أتمكن من المشي. وكنت أمسك بيدي الوصفة التي كتبها لي الأطباء والتي قالوا لي إنها ستهدئ من شدة الألم الذي كنت ما أزال أشعر به. كان الدواء الذي وصفوه لي هو حبوب كوكودامول.
ولكن، وبعد مضي سنوات تسع، أصبحت حياتي كلها تدور حول هذه الحبوب.
تقول مؤسسة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إنه من الممكن أن يدمن الإنسان على مادة الكودائين الموجودة في تركيبة حبوب كوكودامول، ولكن هذا العارض الجانبي يعد نادر الوقوع اذا أُخذت الحبوب تحت اشراف طبي. وهناك ثلاثة أنواع من هذه الحبوب تتدرج في القوة، وكانت أكثرها قوة (الحبوب التي كنت أنا أتناولها) لا تباع في الصيدليات إلا بموجب وصفة طبية.
شعرت بارتياح كبير بعد إجراء العملية. ظننت بأن الألم سيزول في غضون أيام قليلة بعد استئصال الكيس المنفجر خصوصا باستخدام المسكّن الذي وصف لي – أو هكذا اعتقدت على أقل تقدير. ولكن الألم استمر وأصبح أكثر سوءا.
مصدر الصورة
Thomas Dowse
والدي ووالدتي مطلقان، وكنت أقيم حينئذ مع والدي . بعد أيام شعرت فيها بآلام مبرحة، أعادني والدي إلى المستشفى. ووصفت لي هناك المزيد من حبوب كوكودامول وقال لي الأطباء أن أنتبه إلى طبيعة الألم الذي كنت أعاني منه.
جاء في تقرير أصدرته مؤخرا منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ( OECD) أن إفراط الأطباء في وصف المسكّنات قوية المفعول من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى “أزمة صحية واجتماعية متفاقمة” في دول كالولايات المتحدة وكندا وإنجلترا وويلز في بريطانيا. وجاء في التقرير أيضا أن بريطانيا تأتي في المرتبة الثالثة من ناحية سرعة نمو ظاهرة استخدام العقاقير التي تحتوي على مادة الأفيون.
وكشف تحقيق لبي بي سي أجري في العام الماضي بأن الأطباء في إنجلترا (الأطباء العموميون على وجه التحديد) وصفوا هذه العقاقير 24 مليون مرة لمرضاهم في عام 2017، أي بزيادة تبلغ 10 ملايين عن تلك التي وصفوها في عام 2007، مما حدا بأحد المرشدين العلاجيين الذي كان من المدمنين السابقين على هذه العقاقير إلى القول إن خدمة الصحة الوطنية “تخلق مدمنين”.
ويشير بحث أجرته صحيفة صنداي تايمز اللندنية إلى أن أعداد حالات الإفراط في تناول المسكّنات وأعداد الوفيات المتأتية عن ذلك في تزايد مستمر وتبلغ الآن مستويات قياسية. وكشف تحقيق آخر عن أن خمسة أشخاص يموتون يوميا لهذا السبب في إنجلترا وويلز، وأن الوفيات التي تتسبب فيها العقاقير التي تحتوي على الأفيون قد ارتفعت بنسبة 41 في المئة في العقد الأخير لتبلغ الآن 2,000 حالة سنويا.
وبالرغم من أن سبب معظم هذه الوفيات هو مخدر الأفيون المحرم قانونا وليس المسكنات التي توصف طبيا، يؤكد تقرير منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بأن الزيادة في وصف العقاقير التي تحتوي على مادة الأفيون، بل الإفراط في ذلك، من جانب الأطباء لعلاج الآلام تعد عاملا مهما من العوامل المسببة لهذه الأزمة.
كانت الحادثة التي رويتها بالنسبة لي صافرة البداية لصراع مرير مع مرض انتباذ بطانة الرحم ( endometriosis) الشديد، وهي حالة توصف بنمو الأنسجة التي تكون بطانة الرحم في أماكن أخرى من الأحشاء كالمبيضين. واستغرق أمر تشخيص المرض الذي كنت مصابة به ست سنوات وزيارات لا حصر لها للمستشفيات والأطباء. ليس هذا بالأمر الاستثنائي، رغم أن إنتباذ بطانة الرحم يعد ثاني أكثر الأمراض النسائية شيوعا في بريطانيا إلا أنه من أصعب وأعقد الحالات تشخيصا.
في البداية، تناولت جرعة الكوكودامول التي أوصاني الطبيب بتناولها، ولكن لم يمر وقت طويل قبل أن أكتشف بأن الحبوب تحولت إلى هاجس استحوذ عليّ. فقد كنت أتلهف لإزدراد المزيد منها حالما أتناول الجرعة المقررة، وكنت أطلب المزيد من الوصفات من طبيبي العام عند نهاية كل زيارة أقوم بها لعيادته.
يصعب عليّ أن أصف الشعور الذي كان ينتابني عند تناول الحبوب، فقد كانت تخفف من الآلام التي كنت أشعر بها، ولكن كان هناك شيء آخر. فقد كانت تخدر دماغي، مما يخفف من الهلع الذي كنت أشعر به جراء عدم معرفتي بالحالة التي كنت أعاني منها. أما الآن، وعند النظر إلى الوراء وإلى كل ما جرى، كان وضعا مروعا ذلك الذي تسببت به لنفسي.
بعد زيارتي الأولى إلى المستشفى، أصبحت حياتي عبارة عن سلسلة لا تنتهي من الفحوص والعمليات الجراحية كان الأطباء يحاولون من خلالها معرفة طبيعة المرض الذي كنت أعاني منه. وعقب كل تداخل جراحي، كنت أُخرج من المستشفى وبيدي علبة من الحبوب. وكنت دائما أتصل بالمستشفى حال وصولي إلى البيت طالبة المزيد من هذه الحبوب وقائلة إني ما زلت أشعر بالكثير من الألم.
بدأت أشعر بأني أحتاج إلى المسكّنات من أجل أن أحيا حياة طبيعية عادية. وكنت صباح كل يوم أضع عدة علب من الكوكودامول في حقيبتي المدرسية، وكنت أحرص على أن تكون في متناولي كمية أكبر من حاجتي عسى أن تنفد. أتذكر أن والدي سألني ذات ليلة عندما كنا نتناول وجبة العشاء عن سبب حاجتي لتلك الكميات الكبيرة من الحبوب. حاولت التملص من الإجابة، ولكني تيقنت بأنه يشعر بالقلق عليّ.
عند إعادة النظر إلى تلك الفترة، استنتجت بأني كنت أعتمد على المسكّنات لأني كنت بدأت بفقدان السيطرة على مناحي حياتي الأخرى. فقد كان الألم المستمر يمنعني من التركيز أثناء الحصص الدراسية، ولذا فشلت في امتحانات المرحلة الثانوية (ِ A Levels). حصلت على عمل مؤقت في متجر لبيع الملابس، ولكني كنت مضطرة مرارا إلى التغيب بدواعي المرض.
كنت أجهل حينئذ طبيعة العلة التي أصابتني بالتحديد. ولزيادة الطين بلة، بدأ والدي هو الآخر يشعر بالمرض.
كان والدي قد بدأ منذ أسابيع بالشكوى من ألم في الساقين ومن الإعياء والتعب. عزونا نحن الإثنين ذلك إلى الإرهاق ليس أكثر. وعند مراجعة والدي للطبيب، أحاله إلى المستشفى لإجراء بعض التحاليل. وفي أحد أيام شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2011، عندما كنت في الـ 19 من عمري، تسلمت مكالمة هاتفية غيرت مجرى حياتي كليا.
كنت في مكان عملي في المتجر أقوم بنقل الملابس لتعليقها في صالة العرض عندما رن هاتفي المحمول. كان والدي على الخط.
قال لي “كايتي، لدي خبر سيء، إني مصاب بسرطان البروستاتا”.
رميت الملابس التي كنت أحملها، وجريت جريا إلى البيت.
عندما وصلت إلى الدار منتحبة ومرتعشة، وجدت أن والدي لم يكن هناك، فلم يكن قد عاد من المستشفى بعد. كنت لوحدي في البيت والقلق ينتابني، ولذا كانت هناك فكرة واحدة ببالي: أن أبتلع حبتين من الكوكودامول.
بدأت أعتني بوالدي، إذ كنت أذهب إلى السوق لأشتري الطعام وكنت أنظف البيت وأبقيه مرتبا – وكنت في نفس الوقت أصارع الألم الذي كنت أشعر به باستمرار. لم تكن لي سيطرة على أي أمر سوى الحبوب، وكان تناولها يمنحي دقائق من الراحة.
ولكن، ورغم تمكن الأطباء من تشخيص حالة والدي بشكل مبكر، بدأت حالته بالتدهور. وبعد 11 شهرا من موعد التشخيص، توفي والدي فجأة في المستشفى.
مرت الأيام التي أعقبت وفاته كأنها دوامة لا أعرف بدايتها من نهايتها. تقاطر الأقارب على البيت حاملين الطعام. ولكن في معظم تلك الأيام كنت أستلقي على الفراش وكأني مخدرة. كان هناك علاجا واحدا اعتقدت أنه سيساعدني على التأقلم مع الوضع الجديد – تناول جرعات أكبر من الكوكودامول.
بدأ الأمر بالتدريج، فقد كنت أتناول في البدء حبتين فقط فوق الجرعة المقررة، ثم زدتها إلى حبتين أخريين وهلم جرا.
مصدر الصورة
Thomas Dowse
كنت أعرف بأن ما كنت أفعله خطأ كبير، بأن الجرعات التي كنت أتناولها أكبر من اللازم، ولكني لم أعر للأمر أي اهتمام، فقد كان همي الوحيد نسيان كل شيء والشعور بالخدر. أسميت الحالة “غمامة الكوكودرامول” التي كنت أشعر بفضلها بالخدر وكنت أتمكن بواسطتها من ترك الأحزان خلفي والسمو فوقها ولو لفترة وجيزة. ولكن هذه الفترات لم يكتب لها أن تطول، فقد كان ألم فراق والدي يعود بعد وقت قصير من تناولي جرعات الحبوب.
كانت الأعراض الجانبية للكوكودرامول فظيعة حقا، وكانت تشمل الإمساك والغثيان والنعاس. كنت أضطر مرارا إلى الإعتذار من زملائي في العمل لأخرج مسرعة وأتقيأ. كنت أعاني من إمساك متواصل، وكنت متوترة طيلة الوقت.
ذات ليلة عندما كنت في الـ 21 من عمري، دعتني صديقة لي لحضور جلسة نسوية في إحدى الحانات المجاورة. وعندما كنا جالستين في غرفتها استعدادا للخروج قامت بالتأكد من الأشياء التي ستأخذها معها: بطاقة الهوية؟ نعم، نقود؟ نعم، الهاتف؟ نعم. أما قائمتي فكانت تختلف كليا: كوكودامول؟ نعم، علبة أخرى للطوارئ؟ نعم.
تعودت على توخي السرية بشأن تناول الحبوب كيلا تلاحظ صديقاتي، فقد كنت ابتلعها في مراحيض الحانات والنوادي أو عندما كانت الصديقة التي معي تترك الطاولة وتتوجه لشراء المشروبات. كان لتناول الكحوليات أثرا مضاعفا على الحبوب، فقد كنت أشعر وكأنني أحلق في السماء. وبين الفينة والأخرى، كان تناول الإثنين معا يصيبني بالغثيان مما يجبرني على التقيؤ خارج الحانة أو النادي، وكان الجميع يعتقدون بأني أفرطت في الشرب – ولم يعرف الحقيقة سواي.
لم تشخص حالتي إلا بعد أن بلغت من العمر 22 عاما، حيث قيل لي في عام 2014 إني مصابة بانتباذ بطانة الرحم ومتلازمة تكيّس المبيضين. خضعت لمباضع الجراحين مرة أخرى، وقيل لي بعد العملية إن مبيضي الأيمن كان ملتحما بعظم الحوض.
خففت تلك العملية من آلامي إلى حد كبير، وبدأت أشعر بأني عدت إلى حالتي الطبيعية. بدأت بخفض كمية الكوكودرامول التي أتناولها، وعدت إلى الجرعة التي وصفها لي الأطباء أصلا. ولكن هذا الوضع لم يدم طويلا، إذ كانت الحبوب تسيطر عليّ بشدة لا قوة لي على مقاومتها.
كنت مكتئبة، فقد كنت ما أزال أعاني من فقد أبي، كما كنت في علاقة عاصفة مع رجل كان لها أثر سلبي على احترامي لذاتي. لجأت مرة أخرى إلى المسكّنات، إذ كنت مؤمنة بأنها سبيلي الوحيد للتخلص من الآلام الجسدية منها والنفسية على حد سواء.
أخذت بزيادة الجرع التي أتناولها بوتيرة أسرع هذه المرة، وما أن مضى اسبوعان حتى كنت أتناول أكثر من ضعفي ونصف الجرعة الموصى بها. كنت أشعر بأن الحبوب رهن أشارتي في أي وقت، وعندما إنهارت العلاقة التي ذكرتها زاد اعتمادي على المسكّنات.
بدأت الأمور تسير نحو التحسن عندما تعرفت على رفيق جديد في عام 2017. كنت أبلغ آنذاك من العمر 24 عاما. إلتقينا في حفلة وبدأنا نتجاذب أطراف الحديث وبدأنا بالالتقاء بعد ذلك بقليل. كنت أشعر بسعادة كبيرة، إذ شعرت بأن أمرا ما في حياتي على الأقل يسير في الاتجاه الصحيح.
أخبرت رفيقي من البداية بأني أحتاج إلى تناول الحبوب من أجل تخفيف آلام المرض، وحاولت أن أصور الكميات التي أتناولها بأنها كميات عادية. ولكن بعد أن بدأنا بالعيش سوية، وجدت نفسي مضطرة إلى إخفاء الحبوب عسى أن لا يراها. لم أسع إلى استبيان رأي طبيب حول طبيعة مشاعري. وفي أسوأ حالاتي – في عام 2017 – كنت أتناول ثلاثة أضعاف الجرعة الموصى بها.
مصدر الصورة
Thomas Dowse
عندما أنظر إلى الوراء، أرى أني كنت مشوّشة ومرتبكة إلى أقصى الحدود. وفي تلك الليلة المنحوسة العام الماضي عندما استيقظ رفيقي وضبطني وأنا أبحث عن الحبوب في منتصف الليل تيقنت، تلك اللحظة بالتحديد، بأنه أكتشفني على حقيقتي – إمرأة مدمنة. كنت قد أتقنت حيل ستر اعتمادي على المسكّنات إلى درجة جعلتني لا أفكر بأن رفيقي قد يلحظ شيئا.
في اليوم التالي، قررت أن أسعى للحصول على عون. اتصلت بطبيبي، الذي أحالني إلى مؤسسة يقال لها FRANK، وهي خدمة وطنية تعنى بالتثقيف بمضار الإدمان والمخدرات. دلني العاملون هناك على مركز متخصص يساعد المدمنين على التخلص من إدمانهم من خلال النصح والإرشاد.
بدأت بمراجعة أحد العاملين في ذلك المركز، الذي كان يتكلم معي دون أن يتخذ موقفا مني ومن حالتي قط. تحدثنا عن وفاة أبي وعن علاقتي السابقة وعن كيف أدت هذه الأحداث إلى أن أدمن على المسكّنات. وبفضل مساعدته، قررت أن أحدد لنفسي موعدا نهائيا لا رجعة فيه. كان ذلك في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2018، وكان الموعد النهائي الذي حددته لنفسي للتخلص كليا من الإدمان هو الأول من كانون الثاني / يناير 2019.
كنت مرتعبة في البدء، ففي مكان عملي كنت استرق النظر إلى الحبة البيضاء الصغيرة التي كنت أحملها في كفي. كنت أكرهها وأكره نفسي. كنت لا أريد تناولها لمعرفتي بأني لن أتمكن من مقاومة إغرائها وسأفشل في مسعاي.
وكانت أعراض العزوف عن تناول المسكّنات فظيعة بمعنى الكلمة. إذ كنت أشعر بالغثيان والإرهاق والانفعال بشكل مستمر، وكنت أغضب لأتفه الأسباب. وفي بعض الأيام، لم أتمكن حتى من مبارحة الفراش، وكنت كلما أشعر بالألم أتصدى لنفسي كيلا أعود إلى تناول المسكّنات.
ولكن في نهاية المطاف نجحت في تحقيق ما كنت أصبو إليه. وفي نهاية العام، كنت “نظيفة” تماما. كنت أفكر برفيقي عندما كنت أقلل تدريجيا كميات الحبوب التي أتناولها حتى وصلت إلى الصفر.
مصدر الصورة
Thomas Dowse
صممت على متابعة موضوع الإدمان على المسكّنات، فتوجهت إلى الهيئة المشرفة على الأطباء العموميين في بريطانيا، الكلية الملكية للأطباء الممارسين. سألت المسؤولين فيها عن الكيفية التي يتعامل بها الأطباء العموميون مع المسكّنات التي يصفونها لمرضاهم، فقالوا “إن الأطباء مدربون تدريبا متقدما على وصف الأدوية والعقاقير، وهم لا يصفون أي دواء إلا بعد الأخذ بنظر الاعتبار العوامل البدنية والنفسية والاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على صحة المريض الجالس أمامهم”.
وقالوا إنه لا وجود لـ “علاج سهل” للآلام المزمنة، وإنه في بعض الحالات لا يوجد بديل لاستخدام العقاقير التي تحتوي على مواد أفيونية من أجل معالجة الآلام الشديدة التي يشتكي منها المرضى رغم احتمال أن يؤدي ذلك إلى إدمانهم.
كما قالوا إن الأطباء العموميين يحاولون تجنيب مرضاهم مخاطر تناول الأدوية لفترات مطولة، ولذا فهم يميلون إلى وصف أقل جرعات من الأدوية لأقصر فترة، ويستعرضون العلاجات التي يصفونها لمرضاهم بشكل دوري، ويصفون أدوية بديلة إذا وجدوا لذلك سبيلا.
لا ألوم الأطباء، فأنا أعلم أنهم يفعلون أقصى ما بوسعهم لخدمة مرضاهم رغم الضغوط الهائلة التي يتعرضون لها وقصر الوقت والموارد التي تحت تصرفهم.
وكما قال مسؤولون في الكلية الملكية البريطانية للأطباء الممارسين “عندما يدمن أحدهم على مادة ما، يبذل جهودا جبارة من أجل الحصول على تلك المادة”. كنت أنا أبذل هكذا جهود فعلا.
ولكني أعتقد مع ذلك أنه ينبغي فعل المزيد من أجل تنوير المرضى حول التأثيرات الكارثية التي يمكن للأدوية (المسكّنات تحديدا) أن تتسبب بها لحياتهم اذا أدمنوا عليها. لم أختر شخصيا أن أكون مدمنة على المسكّنات، ولكن الإدمان داهمني شيئا فشيئا حتى تمكن مني.
والآن، وبعد أن أكملت 200 يوم دون أن أتناول أي مسكّنات، أذكّر يوميا أن أخبر نفسي بالمسافة التي قطعتها. فإني أشعر أخيرا أني بصحة جيدة ومليئة بالحيوية للمرة الأولى منذ 10 سنوات ونيف. وسنعقد قراننا أنا ورفيقي هذا الصيف. كنت عبارة عن زومبي، أي ميتة تمشي على قدميها، وأشعر بسعادة ما بعدها سعادة لذهاب تلك المخلوقة من حياتي.
في بعض الأحيان، أعثر على علبة مسكّنات قديمة تحت الفراش أو خلف الأريكة. أنظر إلى تلك العلب لبرهة وأتذكر القبضة التي كانت تتمتع بها يوما على حياتي. ثم أسحق العلبة وألقيها في القمامة.
(القصة كما روتها كايتي لألينور لايهي)
[ad_2]
Source link