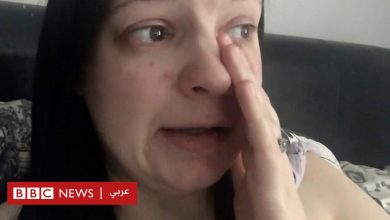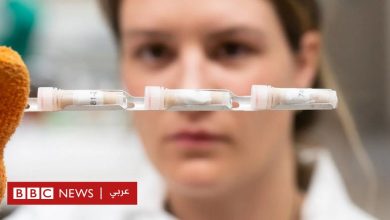كيف تستغل الحكومات الكوارث لكبت الحريات وفرض مزيد من الرقابة؟

[ad_1]
- لوك كيمب
- بي بي سي
تكشف صفحات التاريخ أن السياسيين في أوقات الأزمات يحاولون الحصول على صلاحيات مطلقة للتعامل مع الأزمة، ويرى الباحث لوك كيمب أن التاريخ يعيد نفسه الآن، ويجب أن يحذر المواطنون في الدول الديمقراطية من العواقب.
ثمة مقولة قديمة مفادها أن الأزمة تجلب المخاطر كما تجلب الفرص. وقد أثبت فيروس كورونا أن هذه المقولة تنطبق على الكثير من السياسيين.
وأشارت بيانات مجمعة من مؤشر الحقوق الرقمية في ظل فيروس كورونا ومؤشر الحرية المدنية، إلى أن الكثير من الحكومات حول العالم استجابت للوباء بتوسيع سلطاتها وصلاحياتها. فقد استعانت 32 دولة بعناصر الجيش أو القوانين العسكرية لتطبيق القوانين، وقد أسفر ذلك عن وقوع قتلى وجرحى. ففي أنغولا، أطلقت الشرطة الرصاص على المدنيين وأوقعت قتلى من المدنيين أثناء فرض الحجر الصحي.
ووظفت بعض الحكومات التكنولوجيا الحديثة لتشديد المراقبة الحكومية. فقد استعانت 22 دولة بطائرات مسيرة للمراقبة، وانتشرت برامج التعرف على الوجوه، وفرضت 28 دولة رقابة على الإنترنت، وحجبت 13 أخرى الإنترنت. واستخدمت 120 دولة على الأقل تطبيقات تتبع المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، واستخدمت 38 دولة تدابير أخرى لتتبع المخالطين للمصابين.
ويعد الكثير من هذه التدابير والإجراءات أمثلة على الصلاحيات الاستثنائية التي قد تتذرع بها الدول أثناء الأزمات لتجاوز القوانين المعمول بها. وتختلف صلاحيات الطوارئ من دولة لأخرى، فالكثير منها منصوص عليه في الدستور، من خلال منح المسؤولين صلاحيات معينة في فترات زمنية محددة. وتشترط الكثير من القوانين (وليس كلها) إعلان حالة الطوارئ لمنح هذه الصلاحيات.
ولا شك أن بعض التدابير الاستثنائية ضرورية حين تواجه الدولة خطرا حقيقيا سواء كان عدوا على مشارفها أو مرضا في شوارعها. فقد أنقذت تدابير الحجر الصحي، على سبيل المثال ملايين الأرواح. لكن في المقابل، بعض التدابير قد تكون مبنية على أسس معيبة بشأن المصادر الحقيقة للتهديدات أثناء حالات الطوارئ. وقد تصبح هذه الصلاحيات الاستثنائية عرضة للاستغلال، ما لم تراجعها الدول من آن لآخر، وبمرور الوقت قد يتحول الإجراء الاستثنائي إلى قاعدة مسلم بها.
لا نقصد بذلك بالطبع الاعتراض على التدابير السلسة والمهمة والمفيدة، مثل تدابير الحجر الصحي وفرض قيود على السفر، ما دامت تطبق بشفافية وأسلوب ديمقراطي. وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن التغيرات السلوكية قبل أن تفرض الحكومات الحجر الصحي أسهمت في الحد من انتقال العدوى بنسبة 50 في المئة.
لكن البعض أثار مخاوف من أن يؤدي تشديد الحكومات المراقبة على المواطنين ونشر القوات الأمنية وتوسيع الصلاحيات، إلى مفاقمة الكوارث.
وكان الديكتاتور الروماني واحدا من أول وأشهر الأمثلة على منح صلاحيات الطوارئ للحاكم بموافقة الدولة. ففي حقبة الجمهورية الرومانية، كان مجلس الشيوخ عندما يواجه مشكلة ما، يُعين طغاة ويمنحهم صلاحيات مطلقة، مثل التحكم الكامل في الجيش، وإن كان المجلس يحتفظ لنفسه بسلطة التحكم في ميزانية الدولة.
ومنذ سقوط الإمبراطورية الرومانية، أصبحت صلاحيات الطوارئ أكثر انتشارا. ففي عام 1978، فرضت نحو 30 دولة حالة الطوارئ، وارتفع عددها إلى 70 في عام 1986. وفي عام 1996، وضعت 147 دولة آليات لإعلان حالة الطوارئ.
وبحسب قاعدة بيانات “كورونا نت”، أعلنت 124 دولة حالة الطوارئ في عام 2020 استجابة لفيروس كورونا، وأعلنت عدة دول أخرى حالة الطوارئ في مقاطعات وأحياء معينة.
وحتى قبل الوباء، كان الكثير من الدول في حالة طوارئ دائمة. فمن حق رئيس الولايات المتحدة فرض حالة الطوارئ الوطنية للحصول على طائفة عريضة من الصلاحيات الاستثنائية التشريعية. وفي الولايات المتحدة بلغ عدد حالات الطوارئ سارية المفعول حتى فبراير/شباط 2020، 32 حالة طوارئ، أقدمها يعود إلى 39 عاما. ويقرر كل من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي تمديد حالات الطوارئ الوطنية.
وكانت السلطات الاستثنائية تُمنح لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أثناء الحرب العالمية الأولى بموجب نص دستوري. لكن في عام 2001، منح قانون الوطنية الأمريكي للكونغرس الحق في تمديد صلاحيات المراقبة من تلقاء نفسه. ويطلق بعض الباحثين على هذا النموذج اسم “النموذج التشريعي”، إذ يقر البرلمان صلاحيات استثنائية ويمنح بعض الصلاحيات الجديدة للجهات التنفيذية.
والأكثر إثارة للقلق هو التشريعات الاستثنائية التي تصدر استجابة للتهديدات. فالكثير من قوانين مكافحة الإرهاب التي مُررت في المملكة المتحدة في العقدين الماضيين كانت تشريعات معتادة، لكنها تجعل الناس يألفون الصلاحيات الاستثنائية ويعتادون عليها. وقد يرى بعض النقاد أن مشروع قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم ينص على سلطات مطلقة، لكنه أيضا مُرر في وقت لم يكن مثاليا للاستقصاء والمشاورة.
ثمة شبكة من الوكالات القوية التي تنتفع من صلاحيات الطوارئ، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي تجمع معلومات شخصية وخاصة من الناس وتستفيد منها وتبيعها لجهات خارجية. وتطلق شوشانا زوبوف، من جامعة هارفارد، على هذه السلوكيات “رأس مال المراقبة”.
وبخلاف شركات التكنولوجيا، جمعت أيضا مجموعة من وكالات الاستخبارات حول العالم بيانات واكتسبت سلطات على مدى العقود الماضية. إذ كشفت تسريبات في عام 2013، أن معظم الوكالات الاستخباراتية اتخذت من الحرب على الإرهاب ذريعة لبناء شبكة عالمية من المراقبة التطفلية.
ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، أطلق تشريع مكافحة الإرهاب يد شبكات المراقبة، ولا سيما على الأقليات المسلمة. واتخذت تدابير مماثلة للمراقبة الجماعية في دول عديدة على مدى العقد الماضي، مثل فرنسا وأستراليا والهند والسويد وغيرها، ناهيك عن أجهزة المراقبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في دول أخرى مثل الصين وغيرها من دول العالم.
وتستفيد مجموعة من الشركات من الأرباح والرقابة المترتبة على استخدام الصلاحيات الاستثنائية وتدابير فرض المراقبة الجماعية، كما هو الحال في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول أو مراقبة وتعقب المواطنين أثناء تفشي فيروس كورونا، باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي أو البلوتوث.
ولا يوجد حتى الآن إلا القليل من الأدلة التي تؤيد فعالية المراقبة الجماعية في محاربة الإرهاب أو الفيروسات. غير أن المراقبة لا تزال الحل الذي تلجأ إليه جميع الحكومات كلما وقعت كارثة.
فهل كانت جميع الإجراءات التي فرضت أثناء تفشي فيروس كورونا شرا لا بد منه لضمان سلامة الجمهور؟ ويأتي وضع استعراض للدراسات عن فعالية تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا، وتدخلات الشرطة والجيش والمراقبة، وفرض حالات الطوارئ في المراتب السبع الأخيرة بين تدابير الاستجابة للوباء.
وثمة أدلة متزايدة على أن الصلاحيات الاستثنائية لا تستخدم لإنقاذ الأرواح بقدر ما تستغل لمنفعة الحكومات، إذ أشارت دراسة إلى أنه كلما زادت السلطات التي تمنحها تشريعات الطوارئ للجهات التنفيذية، ارتفع عدد ضحايا الكارثة الطبيعية.
وأشارت منظمة مراسلون بلا حدود في مؤشر الصحافة العالمية عام 2020، إلى أن الكثير من الدول التي تقمع حرية الصحافة استغلت فيروس كورونا لتشديد الرقابة على المواطنين. وأشارت دراسة حديثة إلى أن 87 في المئة من سكان العالم يعيشون في دول قمعية أو مغلقة أو مقيدة للحريات العامة. وربما يفاقم الوباء أوضاعا كان الكثير من المواطنين يعانون منها في دول عديدة.
ويتمثل الخطر الأكبر في أن تستغل الحكومة حالة الطوارئ لتجاوز القوانين. فلولا حالة الطوارئ في ألمانيا التي دامت 12 عاما لما ظهرت ألمانيا النازية. فقد بدأت في عام 1933 بعد أن تذرع هتلر بالمادة 48 من دستور جمهورية فايمار، التي تتيح له استخدام أحكام الطوارئ دون موافقة البرلمان.
وقد كان انتهاك الصلاحيات الاستثنائية أيضا في روما مؤشرا على الانتقال من الجمهورية إلى الإمبراطورية، وبداية مركزية السلطة السياسية في العصور الوسطى، وتكريس الأنظمة القمعية في تشيلي وجنوب أفريقيا.
كبت الحريات
تستجيب الحكومات دائما للكوارث بمنح صلاحيات إضافية للقائمين على رأس السلطة في البلاد وتقييد الحريات وإسكات الأصوات بطريقة وحشية وعشوائية وأطلق على ذلك اسم “الاستجابة بالقمع”.
ويستغل بعض الساسة المخاوف من أن تجتاح البلاد فوضى عارمة في أوقات الكوارث، رغم أن أغلبية الأدلة العلمية والتاريخية تتعارض مع هذه الرؤية المتشائمة للبشر. وفندت دراسة أجراها باحثون في إدارة مخاطر الكوارث، فكرة الذعر الجماعي في حالة وقوع الكارثة وذكرت أنها مجرد خرافات نادرا ما تحدث.
وتناولت ريبيكا سولنيت في كتاب “جنة مبنية في الجحيم”، وروتجر بريغمان في كتاب “الجنس البشري”، نزوع المجتمعات لإظهار السلوكيات الإيثارية والتنظيم الذاتي في أوقات الكوارث، وقد شهدنا ذلك منذ بداية تفشي فيروس كورونا، بدءا من تضافر جهود المجتمع لتصنيع معدات وقاية شخصية منخفضة التكلفة بطرق مبتكرة ووصولا إلى الجهود الجماعية المنظمة لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة. غير أن مبالغة الحكومات وعناصر الجيش في فرض التدابير الأمنية قد تفاقم الكوارث.
وبينما ثبت أن الذعر الجماعي مجرد أكذوبة، فقد أشارت دراسة إلى ظاهرة ذعر الصفوة. وهذا يشمل رد فعل الصفوة المبالغ فيه حيال الخوف من الذعر (مثل إرسال قوات لمناطق بعد وقوع الكارثة) أو إثارة الذعر لأغراض سياسية (كما هو الحال في الحرب على الإرهاب في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول) أو ببساطة الإصابة بالذعر.
والمفارقة أن رد الفعل القمعي يؤدي إلى تقييد قدرات المجتمعات على تنظيم نفسها ويثير الذعر بين الصفوة. فقد خسر العالم أسابيع وأياما كان من الممكن أن تساعد في مكافحة الوباء بسبب القيود المشددة التي فرضتها الصين على نشر المعلومات عن الوباء. وهذا المثال قد يثبت أن المراقبة تمنع الحكومات من السماع للمعلومات التي يدلي بها المواطنون والاستجابة لها.
وبالمثل، فإن الدول التي شهدت أعلى معدلات إصابة بالفيروس، لم يوصف سكانها بأنهم غير جديرين بالثقة أو أكثر عرضة للإصابة بالذعر، بل طالت القائمين على الحكم فيها اتهامات بالفساد أو عدم القدرة على معالجة الأزمات.
فقد وجهت انتقادات للحكومة البريطانية على سبيل المثال بسبب التأخر في فرض تدابير الحجر الصحي على أمل أن تنجح خطوة “مناعة القطيع” المبكرة، وأثيرت مزاعم بأن الحكومة منحت بعض العقود لشركات دون منافسة. وشددت الحكومة على أنها منحت العقود سريعا استجابة لضغوط قطاع الخدمات الصحية قبل الوباء.
وأشار النقاد في الولايات المتحدة إلى بطء الحكومة في اتخاذ الإجراءات لمكافحة الوباء والفحوص التشخيصية المعيبة والتضليل والاستغناء عن موظفين وتراجع الإنفاق على مركز مكافحة الأمراض قبل الوباء.
وعلى النقيض، كانت تايوان واحدة من أفضل الدول من حيث الاستجابة للوباء، إذ بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة 10 حالات فقط. وكانت تايوان من أوائل الدول التي استجابت للوباء بعد أن لاحظ مسؤول صحي منشورا على منصة للنقاش عبر الإنترنت حظي بتفاعل كبير.
واستعانت السلطات بقراصنة إنترنت لمنع التهافت على شراء معدات الوقاية الشخصية والكمامات، والبحث عن الصيدليات التي نفد منها المخزون، في إطار جهود الوزير الرقمي، أودري تانغ، لتحقيق الديمقراطية الرقمية.
صحيح أن الوباء تطلب تضحية واتخاذ قرارات صعبة، لكن هناك طرق عديدة لمكافحة الوباء بأسلوب ديمقراطي، من خلال الاستفادة من السلوكيات الإيجابية للمواطنين، وزيادة المراقبة لقرارات الحكومات، وحماية الحريات الشخصية.
قد يكون الوباء مجرد أحد التهديدات التي سنواجهها خلال القرن القادم، بدءا من تغير المناخ ووصولا إلى الحروب السيبرانية والفيروسات المعدلة وراثيا.
وسيكون أمامنا خياران في العقود المقبلة، إما أن نسمح للكارثة بأن توجه العالم نحو الرقابة المفرطة والفساد أو أن تساعدنا على تحقيق الديمقراطية والتكافل والتضامن. فإذا أصرت الحكومات على الاستجابة للكوارث بالقمع وكبت الحريات، ستكون الكارثة الحقيقية هي أن نسقط في عالم مليء بالأغلال.
[ad_2]