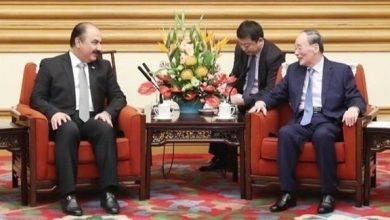كيف تنعكس الوظيفة التي نشغلها على هويتنا وشخصيتنا؟

[ad_1]
- كيت مورغان
- بي بي سي
غالبا ما نرى أن الوظائف التي نشغلها تشكل إحدى التفاصيل المُحددة لشخصية كل منّا، لكن إقدام المرء على ربط هويته بوظيفته أكثر من اللازم، قد يكون أمرا خطيرا. فما الذي يمكن أن نفعله حيال ذلك؟
للوهلة الأولى، قد لا يبدو لك أن ثمة ارتباطا بين اسم “مولر”، الذي يشكل اللقب العائلي الأكثر شهرة في ألمانيا وسويسرا، و”ميلنيك” الذي يحتل المرتبة نفسها في أوكرانيا، لكنك ستعرف إذا كنت مهتما باللغات التي يتحدث بها أبناء هذه الدول، أن الاسمين يعنيان “الطحان”، أي من يعمل في طحن الحبوب.
وإذا انتقلنا إلى سلوفاكيا، فسنجد أن اللقب العائلي الأكثر شيوعا هناك هو “فارغا”، وهي مفردة تعني الإسكافي، أي من يعمل في مجال صنع الأحذية. الأمر لا يختلف كثيرا في دول مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة، إذ ستجد “سميث” هو اللقب العائلي الأشهر. ويشكل هذا الاسم جزءا من المُسميات، التي تُطلق باللغة الإنجليزية على ممتهني العديد من الحرف، كـ “الحداد” ((Blacksmith و”صائغ الفضيات” Silversmith)) و”صانع الأقفال” (Locksmith) و”صانع الأسلحة” (Gunsmith).
وتعود هذه الأسماء إلى العصور الوسطى، عندما كانت المهنة التي يعمل بها المرء، تشكل سمة مميزة ومُحَدِدة لهويته، إلى حد تحولها إلى اسمه بشكل حرفي.
الآن بات الوضع مختلفا، إذ لم تعد المهن التي نشغلها، تعكس نفسها حرفيا على أسمائنا، وذلك رغم وجود فرضية يُطلق عليها اسم “الحتمية الاسمية” تشير إلى أن المرء ينجذب إلى المجالات المهنية التي تناسب اسمه. مع ذلك، لا تزال تلك الأدوار الوظيفية، تشكل جانبا رئيسيا من هويتنا، فمن بين أولى الأسئلة، التي ينزع كل منّا إلى طرحها على من يتعرف عليه حديثا، سؤال يتعلق بالوظيفة التي يشغلها.
على أي حال، يبدو منطقيا من أوجه عدة أن نعتبر المهنة التي يعمل بها المرء؛ إحدى التفاصيل المُحدِدَة لشخصيته وهويته، إذ أنها قد تمثل مفتاحا للتعرف على قيمه واهتماماته وخلفيته. كما قد تساعدك – بشكل شخصي – على إيجاد موضوعات مشتركة، للحديث فيها مع الغرباء الذين قد تلتقيهم في حفل ما، مما يفيد في إزجاء الوقت، دون إحراج أي منكم.
في كل الأحوال، بات الكثيرون منّا يُعرّفون أنفسهم، عبر المهن التي يشغلونها، وهو ما يلحق الضرر بهم في كثير من الأحيان. فكيف أصبحت مهنة المرء مرتبطة بشكل وثيق للغاية بهويته؟ وهل فات الأوان لأن نُفرّق بين التصورات التي يُكوِّنها كل منّا عن نفسه، وحياته المهنية أم لا؟
للوظائف مكانة متجذرة في هويتنا، إلى حد أن من بين أول ما تفعله عندما تقابل شخصا ما للمرة الأولى، أن تحدثه عن وظيفتك
العلامات الخاصة بالهوية
ترى آن ويلسون، أستاذة علم النفس في جامعة ويلفريد لورييه بمدينة أونتاريو الكندية؛ أن وقائع التاريخ تشير إلى أن الفرصة لم تسنح لغالبية الناس لكي يختاروا المهن التي يعملون فيها، قائلة إن “الأمر عادة كان يتعلق بانتقال وظيفة ما من جيل لآخر، فإذا كان والدك نجارا فستصبح أنت كذلك. أو ربما سيحصل المرء على الوظيفة، بناء على الفرص المتاحة له في هذا الشأن لا أكثر”.
لكن الأعوام الخمسين الماضية شهدت زيادة في فرص التعلم المتاحة للناس، ما قاد إلى ظهور وظائف أكثر تنوعا، ومزيد من مستويات الدخل بالتبعية. وأدى ذلك أيضا إلى أن يصبح شغل هذه الوظيفة أو تلك، عاملا لا يُستهان به في تحديد تصوراتنا عمن حولنا على نحو أكثر دقة. فعندما يقول لك شخص ما إنه جراح، فستفترض أنه نال قدرا رفيعا من التعليم ويحصل على دخل كبير أيضا. والدخل والتعليم يشكلان اثنيْن من المعايير، التي يمكن أن تحدد مكانة المرء في المجتمع، وتؤثر على الكيفية التي تحكم بها عليه لاحقا. بطبيعة الحال، يرحب الكثيرون بتقييمهم على هذه الشاكلة، لأنهم يرغبون في ربط أنفسهم بالثروة أو الإنجازات، التي توحي بها ألقابهم المهنية.
وتقول ويلسون في هذا الشأن: “يصدق ذلك بشكل خاص بين `الصفوة المتعلمة`، فبالنسبة لمن يعملون في وظائف معينة ومن ينتمون إلى طبقات اجتماعية بعينها، غالبا ما يهتمون بالطريقة التي يُعرِّف بها المرء نفسه، والطريقة التي يُعرِّفه بها الآخرون كذلك”.
لكن المشكلة تتمثل في أن من يسمحون لوظائفهم بلعب الدور الأكبر في تحديد هوياتهم، ربما يلحقون الضرر بأنفسهم وليس العكس. فبحسب ويلسون؛ قد يؤدي تكريس الناس قدرا أكبر من اللازم من وقتهم وطاقتهم لمجالهم المهني، إلى إصابتهم بحالة نفسية، يُطلق عليها اسم “التورط”، وهي تلك التي تتلاشى فيها الحدود تقريبا، بين حياتهم الشخصية والمهنية.
وتشير ويلسون إلى أن ذلك يحدث غالبا، للأشخاص الذين يشغلون وظائف يحددون بأنفسهم التفاصيل الخاصة بها ولو نسبيا. فهؤلاء لا يلتزمون مثلا، بمواعيد ثابتة للعمل يوميا، من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساءً. وينطبق ذلك على من يعملون في مناصب تنفيذية يحظون فيها بصلاحيات كبيرة، مثل المحامين والأطباء ورجال الأعمال والأكاديميين وغيرهم، ممن يحددون مواعيد عملهم بأنفسهم. ويمكن أن ينتهي المطاف بأولئك الأشخاص – كما تقول ويلسون – إلى أن تهيمن وظائفهم، على “جانب كبير من الوقت في حياتهم، أو ربما تحظى بالجانب الأكبر منه”.
فخ “التورط”
وتقول ويلسون إن هناك بعض المؤشرات الشائعة التي تفيد بحدوث حالة “التورط” هذه، مثل التفكير في العمل حينما لا يكون المرء فيه من الأساس، وأن يتحدث عنه كذلك خلال الدقائق الثلاث الأولى من أي محادثة يشارك فيها. ومن شأن حدوث هذه الحالة، فتح الباب أمام العمل لـ “التهام وقتك وهويتك، وتقليص المساحة المتاحة للهوايات والاهتمامات في حياتك. كما يؤدي ذلك إلى أن يصعب عليك التواصل مع أشخاص، لا يشكلون جزءا من حياتك المهنية”.
وعندما تصبح عالقا بشدة في شَرَك وظيفتك، يبدأ مجالك المهني في تحديد ملامح هويتك. كما يعني سقوطك في هذا الشَرَك، أنك ربما ستبدأ في السماح لعملك، بتحديد قيمتك كذلك، وهو ما قد يكون له آثار كارثية.
وتوضح ويلسون رؤيتها في هذا الشأن بالقول: “إذا ربطت (قيمتك الذاتية) بمجالك المهني، فستؤثر النجاحات والإخفاقات التي تحدث لك في هذا المجال، على هذه القيمة بشكل مباشر. ولأننا نعيش في مجتمع تقل فيه احتمالية أن يبقى المرء في وظيفة واحدة طوال حياته، قد يؤدي تغيير المرء لمساره المهني أو فقدانه لوظيفته، إلى مواجهته أزمة في الهوية”.
يندرج من يعملون في وظائف تُوصف بأنها مهن لـ “الصفوة”، بين من تزيد كثيرا احتمالات تحديد هويتهم والحكم عليهم وفقا لمجالاتهم المهنية، وبين من يعانون من حالة “التورط” كذلك
فضلا عن ذلك، لا تقتصر التبعات السلبية لحالة “التورط” تلك، على كونها تؤثر على الطريقة التي ننظر بها لأنفسنا على المستوى الشخصي. إذ تقول جانا كوريتز، وهي مُؤسِسَة عيادة طبية في مدينة بوسطن الأمريكية، تتخصص في التعامل مع مشكلات الصحة العقلية التي تصيب من يعملون في وظائف حافلة بالتوترات والضغوط، إن وجود ارتباط بين القيمة الذاتية لشخص ما ومجاله المهني، يمكن أن يؤدي إلى أن تتحول المشكلات التي يواجهها في مجال عمله، إلى عقبات يصعب عليه كثيرا تجاوزها.
وتوضح كوريتز رؤيتها هذه بالقول: “من الحتمي أن يحدث شيء ما في نهاية المطاف.. تسريحٌ للعمال، أو ركود، أو أن يتم الاستحواذ على الشركة التي تعمل فيها، لتجد فجأة أن وظيفتك ليست تلك التي اعتدتها. ويصبح الأمر ذا طابع وجودي بحق، بالنسبة لمن يعانون من ذلك (حالة التورط)، ويتعاملون معه باستراتيجيات تكيف بائسة، نظرا لأنه حدث مُزلزل. ويؤدي هذا إلى الإصابة بالاكتئاب أو القلق أو حتى تعاطي المخدرات”.
لكن غالبية من تصبح هويتهم متمحورة حول مجالاتهم المهنية، لا يدركون ذلك إلى أن يواجهوا مشكلة ما. وتقول كوريتز في هذا الصدد إنها تتعامل كطبيبة “مع أشخاص لا يشعرون بالارتياح، إزاء تحديد الآخرين تصوراتهم حيالهم من خلال الوظائف التي يشغلونها”. المفارقة كما تضيف كوريتز، أن غالبية هؤلاء الأشخاص، يقولون في الوقت نفسه إنهم يعملون في الوظائف التي طالما حلموا بها، أو في المجالات التي تروق لهم.
هوية ثقافية جديدة
رغم ذلك، فربما تكون لدينا الآن فرصة نادرة للفصل بين شخصيتنا وهويتنا. فالوباء الذي أدى إلى تعطيل إجباري لكل جوانب حياتنا، خاصة المجال المهني، قاد الكثيرين إلى تحديد ما هو مهم بحق في الحياة بالنسبة لهم. فالبعض بدأ يمارس هوايات جديدة، بينما طوّر آخرون روابطهم مع الأسرة والأصدقاء.
ويقول كلاي روتليدج، أستاذ علم النفس في جامعة نورث داكوتا ستَيت بالولايات المتحدة : “عندما نواجه تجارب وخبرات تُذَكِرنا بأن وجودنا كبشر أمر عابر، وأن المآسي قد تحدث دون مقدمات تقريبا أو حتى بدون سابق إنذار على الإطلاق، نميل إلى أن نشعر بأن لدينا حافزا لأن نحدد الأشياء التي تجعل الحياة جديرة بأن تُعاش”.
ويعني ذلك أنه بينما ستظل الوظيفة التي يشغلها كل منّا جزءا – بالطبع – من العوامل التي تحدد هويتنا والحكم علينا بشكل عام من جانب الآخرين، فإننا قد نكون الآن في مرحلة تحول، يصبح فيها المجال المهني، مجرد عامل مهم في هذا الصدد، لا العنصر الأكثر أهمية.
وتشير ويلسون إلى أنه ليس بالأمر السيء أن يشغل المرء الوظيفة التي يحبها، أو أن يعتبر أن ما يقوم به لكسب العيش هو جزء مهم من هويته. لكنها تردف بالقول إن القضاء على منظومة، يتم فيها تحديد هوية الناس بشكل أساسي أو حصري، من خلال وظائفهم، يتطلب ما هو أكثر من إدراك أن ثمة مشكلة تترتب على ذلك، أو إعادة ترتيب أولوياتنا في أعقاب الوباء الذي لا يزال يجتاح العالم. فالأمر سيتطلب تغييرا في العقلية، من شأنه نبذ فكرة، أن لكل شخص مهنةً مُقدرة له تتحدد عبر هويته، وأن هدفنا من الحياة يتعين أن يكون اكتشاف هذه المهنة.
على أي حال، يحتاج تغيير هذه الطريقة في التفكير، الشروع في العمل على ذلك الصعيد، قبل وقت طويل من أن يخوض الناس غمار العمل بالفعل. وتُظهر الدراسات والأبحاث أن الضغوط المتعلقة بضرورة أن يجد المرء “الوظيفة المُقدرّة” له، تجعل من لا يزالون في مرحلة الدراسة، يشعرون بالضياع والاكتئاب. بل إن الأمر يمتد إلى الأطفال الصغار، الذين يُقال لهم بشكل ما، إن المجال المهني الذي سيختارونه، سيصبح جزءا من هويتهم والشاكلة التي سيصبحون عليها في المستقبل. ولتتذكر هنا مثلا، كم من المرات يُسأل فيها الأطفال اليوم، عن الوظيفة التي يريدون العمل فيها عندما يكبرون.
ورغم أن مناقشة مسألة المجال المهني المستقبلي مع الأطفال، خاصة الفتيات الصغيرات، يمكن أن يساعدهم على التعرف على ما ينطوي عليه مستقبلهم من احتمالات لا تعد ولا تحصى في هذا الصدد، فإن ويلسون تقول إن سؤال الصغار عن الوظيفة التي يريدون العمل فيها قد يكون له تأثيرات جانبية. فـ “فكرة أن مرحلة الطفولة، هي الفترة التي نريد من الأطفال أن يحددوا خلالها المسار الذي ستأخذه حياتهم، قد تؤثر على مدى ربطنا – كبالغين بعد ذلك – بين هويتنا ووظائفنا”.
وبينما يمكن أن يكون لدى الأطفال، فرصة لعدم الوقوع في شَرَك ربط هويتهم بمجالات عملهم المستقبلية، نظرا لأن بوسع الآباء والأمهات تغيير الطريقة التي يتحدثون بها معهم في هذا الشأن، فإن لدى البالغين أيضا القدرة على إنقاذ أنفسهم من مواجهة ذلك المأزق. فقد يساعدهم في هذا الصدد، التفكير في تخصيص فترة ما للراحة والاسترخاء والتواصل اجتماعيا مع أُناس لا يمتون لمناخ العمل بصلة. ورغم أنه قد يصعب عليك اكتساب أصدقاء جدد بعدما وصلت إلى مرحلة معينة من العمر، فإن انضمامك إلى تجمعات اجتماعية أو أندية، قد يشكل عاملا مساعدا لك على هذا الصعيد. علاوة على ذلك، يمكن أن يمثل اكتسابك هوايات جديدة أمرا مفيدا للغاية، طالما كانت لا ترتبط بعملك، بأي شكل من الأشكال.
لكن كوريتز تحذر من أن هوية الإنسان تتطور بمرور الوقت. وتعرب عن مخاوفها من تبعات محاولة إجراء تغييرات واسعة النطاق للغاية وبسرعة أكثر من اللازم، في هذا الشأن. وتشجع هذه السيدة المترددين على عيادتها، على أن يضيفوا ببطء عوامل جديدة، تتحدد من خلالها هوياتهم، قائلة “بدلا من إجراء تغييرات عنيفة وشديدة الصعوبة، فلتكتسب هوايات (جديدة) تدريجيا، ولتتعرف على أصدقاء (جدد) بشكل تدريجي أيضا. وفي نهاية المطاف، يتعين عليك أن تضفي التنوع على حياتك وعلى نفسك، تماما كما تفعل مع محفظتك المالية”.
[ad_2]
Source link